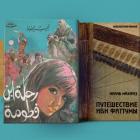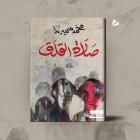معرفة
العرب والسادس من أكتوبر
٦ أكتوبر: ميلاد الهيبة العربية على خريطة السياسة العالمية، والتحوّل الجيوسياسي الذي جدّد شباب العرب وصاغ لهم دورًا عالميًا جديدًا
 الرئيس أنور السادات مع قادة الحرب في غرفة العمليات المصرية خلال حرب أكتوبر
الرئيس أنور السادات مع قادة الحرب في غرفة العمليات المصرية خلال حرب أكتوبر
حين وصف بعضهم 6 أكتوبر بأنه بعثٌ أو ميلادٌ جديد للعرب، وحين ذهب آخرون إلى أنه أعظم مجدٍ لأيام العرب منذ قرنٍ ونصف قرنٍ على الأقل، أي لقطة الأوج والذروة في تاريخهم الحديث جميعًا، لم يكن ذلك من قبيل الحساسية أو المزايدة العاطفية، ولا كان فيه من الرومانتيكية الجامحة أو المجنَّحة أكثر مما فيه من الموضوعية العالمية الصارمة. وإذا كان هناك من يرى في ذلك كثيرًا من المبالغة، وقليلًا من الدقة العلمية، وأن 6 أكتوبر مرحلةٌ هامة من مراحل الصراع فقط، وتغييرٌ كميّ لا كيفي بعد، فإن الاختلاف في النهاية نسبي، وخطر التقليل قد يكون أسهل، ولكنه أسوأ من خطر التهويل. ويبقى 6 أكتوبر تغييرًا ضخمًا وجذريًا بكل مقياس وعلى أي أساس.
ذلك لأنه بقدر ما يكون عمق السقطة السابقة يكون ارتفاع القفزة اللاحقة. ولا يستطيع أن يقدّر معنى ومدى وحجم النصر العربي في أكتوبر إلا من يستطيع أن يتخيّل مدى الانهيار والسقوط ونوع المصير الذي كان يمكن أن ينتهي إليه العرب لو أنهم هُزموا فيه فوق هزيمتهم في يونيو وبعدها.
ولو أننا فكرنا بهدوء وواقعيةٍ فيما كان يُراد بنا ويُخطَّط لنا على أيدي العدو وأطماعه وطموحاته، لتأكد لنا بلا أدنى شبهة أننا — على الأقل وعلى الأسوأ — قد نجونا من خطرٍ ماحق كان يُدبَّر لنا، وكان يمكن فعلًا لو تحقق أن يودي بنا. وعلى الأغلب والأرجح قد ضمِنّا مستقبلنا وآمَنّا مصيرنا إلى الأبد. وعلى الأكثر والأحسن سوف نحقق كل أهدافنا وآمالنا القومية العظمى كاملةً يومًا ما في المستقبل، القريب أو البعيد. أو كما يقول بهاء الدين:
«هزيمة يونيو لم تجعلنا نركع، ولكن ظل سيفها مسلّطًا فوق رؤوسنا، قريبًا جدًا من أعناقنا. حرب أكتوبر كسرت هذا السيف المسلّط، وحطّمت القيد الذي كان يكبّلنا…».
فليس سرًا أن نكسة يونيو كانت قد أصابت الوجود العربي في مقتل أكثر مما كانت جُرحًا داميًا أو كسرًا أليمًا، وقدَّر البعض ما بين جيلٍ إلى جيلين حتى يخرج العرب من كارثتها العسكرية ويعيدوا بناء قواتهم المسلحة. بينما ذهب ريمون آرون إلى أن العرب لن يفيقوا من هول ما حدث إلا بعد قرنٍ كامل.
ففي يونيو خسرنا في ستة أيامٍ سوداء ليس فقط ما كلّفنا ستة أعوامٍ حالكة كاحلة من الانهيار والعار والتمزق ومهانة الهزيمة — كل يومٍ بسنة — ولا كذلك ما قيمته ستة آلاف مليون جنيه من السلاح وحده خسائر مباشرة، أي كل يومٍ بألف مليون جنيه. هذا عدا ستة آلاف مليون أخرى خسائر مادية واقتصادية غير مباشرة، لكنها — أكثر من ذلك جميعًا — شوَّهت ستة آلاف سنةٍ عريقة من التاريخ المجيد، كل يومٍ بألف سنة.
ولم تكن بشاعة الهزيمة لتكمن في ذاتها فحسب، فالعرب قد عرفوا وامتصّوا هزائم كثيرة في تاريخهم المفعم. ولا كانت كذلك في حجمها، وقد كان مخيفًا ومهينًا بصورة غير متصورة، وإن لم تكن بالضرورة غير مسبوقة، إنما كان هول الهزيمة في مصدرها ومعناها. فمن مثل عدونا الإسرائيلي المعقَّد القميء بكل أحقاده وصغاره وسُعاره، وأكثر منها وأخطر: خططه وأوهامه المجنونة ونواياه المعلنة والمكتومة كاستعمارٍ استيطاني، إحلالٍ إبادي وأبدي؛ من مثل هذا العدو كانت الهزيمة إذلالًا دمويًا مشينًا للماضي والحاضر برمَّته، يسفحهما سفحًا، ونذير شؤمٍ سوداويًّا للمستقبل يشدّه إلى الأبد.
معنى نكسة يونيو
من هناك جميعًا، لم يكن من المبالغة في شيء أن تُعَدّ سنوات ما بعد يونيو السوداء بمثابة ردة في تاريخ العرب الحديث إلى «العصور المظلمة». وفي الوقت الذي كان العالم يطفر طفرًا نحو آفاق عصر جديد ونحو حضارة لم يسبق لها مثيل في درجة التطور والتعقيد والإمكانيات، وحتى المتخلِّفون كانوا يلهثون للحاق بالعصر، بدا للبعض كما لو أن العرب — وقد انزلقوا وحدهم في حُمَأَة هذه الرجعة التاريخية — قد أصبحوا كأنهم أمة منقرضة لن تقوم لها قائمة، ميؤوسٌ منها، شاخت واستنفدت أغراضها ومبرر وجودها، وتلك فقط أمارات الزوال وآلام الاحتضار. أما من ترفّق منهم فقد قال إن العرب قد توقّف بهم التطور عند صلاح الدين أو على الأكثر عند محمد علي…
ولم يكن ذلك صحيحًا بالطبع، بل بالقطع، ولكن كان لا بد من تحدٍّ عمليٍّ قاطع. ومن ثم جاء السادس من أكتوبر بمثابة بداية عصر النهضة العربية الحديثة بعد تلك العصور المظلمة التي انتهت إليها النكسة. لقد ردّ هذا اليوم اعتبار العرب في العالم، ونسخ كل النظريات والنظرات الاستخفافية والاستهزائية التي نُسِجت حولهم، وأعاد تأكيد وجودهم إنسانيًا، كما أعاد إقامة تاريخهم على قدميه بعد أن كان قد انكفأ على وجهه ثم انقلب على رأسه.
غير أنه، أكثر من ذلك أيضًا، ساعد على وضعهم في مكانهم الحق والمستحق في العالم كقوة كبرى كامنة أو قادمة. لقد فتح باب الأمل كاملًا أمامهم لا ليلحقوا بالعصر فقط، بل ليسبقوه إن أرادوا، بحيث يمكن لنا — ربما بقليلٍ من مبالغة ولكن بأكثر منه من الصحة — أن نعتبر السادس من أكتوبر بمثابة البداية المسبقة والطاهرة للقرن الحادي والعشرين في تاريخهم الحضاري.
بل أكثر من قرن جديد، كوكب جديد. فلو أننا فقط نجحنا — وهذا شرط لازم — في أن نستكمل المعركة والنصر بحيث نستخرج منهما كل نتائجهما المنطقية ونعتصر ثمراتهما الطبيعية كاملة، لكنا بمثابة من انتقل إلى كوكب جديد. أليس هذا في النهاية معنى حديثنا الشائع عن البحث عن مكانٍ جديد تحت الشمس؟
أوَلم نكن بعد يوليو — كما رددنا كثيرًا — في مفترق طرق مصيري وعنق زجاجة تاريخي؟ إما أن نفشل فننزلق إلى الخلف عشرات السنين حبيسي عنق الزجاجة المغلقة، وإما أن نقتحم عنقها فنظفر منطلقين إلى أوسع آفاق المستقبل وأعرض إمكانيات التطور، نخترق حاجز التخلف، نحقق الوحدة، وندخل دائرة القوة والسيادة العالمية، إلى آخره، إلى آخره… حسنًا، لقد قررت المعركة الاختيار الأخير.
الآثار العالمية
وتستطيع الآن أن تحصر آثار الهزيمة في يونيو في ثلاثة مجالات نحللها تباعًا، عالميًا، قوميًّا ووطنيًّا، فأولًا على المستوى العالمي لم يكن هناك أدنى شك في أن العرب فقدوا كثيرًا جدًا من وزنهم السياسي ومن هيبتهم ومكانتهم الدولية، وانتقلوا في معادلة القوة العالمية قرب تخوم خط الخمود، وتحولوا على خريطة استراتيجية السياسة الدولية إلى منطقة ضغط منخفض، أي إلى «جيوبوليتيكي» أغرى تيارات ضغوط القوة من حوله ومن بعيد بالتدفّق لملء التخلخل الناشئ، ولا نقول الفراغ.
تضاءلت — علينا من أسف أن نعترف — قامة العرب في المجتمع الدولي وخفّت موازينهم في حساب الصراعات العالمية، وبدا كما لو قد أتى على الإنسان العربي حينٌ من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا، حتى لقد طمع فينا أحيانًا الصغار قبل الكبار، القوى المحلية المجاورة قبل القوى العظمى النائية. بل لقد تكامل الاثنان في مشروعات ومخططات مشتركة بزعامة القوة الأعظم المعادية وهي الولايات المتحدة، وكانت الاستراتيجية العظمى في هذا هي الحصار والعزل في الخارج، والضرب والتفتيت في الداخل.
فمن ناحية أخذت الولايات المتحدة تمدّ يدها لإسقاط المنطقة كاملة في قبضة نفوذها وفرض الوصاية عليها، بطرد القوة المكافئة والمضادة منها، وتصفية النظم الوطنية بها، ثم تقنين السيادة الإسرائيلية المباشرة عليها. ومن ناحية أخرى أخذت تمهّد — بالسلاح والاقتصاد وبالاستراتيجيتين الإقليمية والبحرية — لخلق مناطق «أقطاب مضادة» للمنطقة العربية على ضلوعها مباشرة، سواء في آسيا أو في أفريقيا، ترث دورها القيادي في الشرق الأوسط الكبير وتنتزع منها زعامتها فيه إلى الأبد، وذلك بزعم أنها أصبحت مجرد جسم مترهِّل متخلِّف مضروب، وإن كان غنيًّا، وعاجزًا ثقيل الحركة بقدر ما هو ضخمٍ ومترامٍ.
على المستوى القومي
هذا عالميًا، أما قوميًا فلم يكن شكٌّ أن الضربة التي أصابت العرب عامة قد أساءت إساءةً بالغة إلى مصر خاصة، باعتبارها عاصمة العرب استراتيجيًا، والقوة الوطنية الكبرى التي يقع عليها تاريخيًا وجغرافيًا وديموغرافيًا وتكنولوجيًا مسؤولية الدفاع القومي في الصف الأول والتحليل الأخير. ولما كان هذا العجز العارض قد جاء في مرحلةٍ عرضية هي الأخرى، أخلّ فيها البترول بدرجة أو بأخرى بتوازنات القوة بين الدول العربية نفسها، فقد استغلّ الاستعمار هذه الفرصة للطعن في زعامة مصر والتشكيك فيها — محاولة انتزاعها أمر غير وارد أصلًا، بترول أو لا بترول، مستحيلة، ضد الطبيعة والجغرافيا والتاريخ والمستقبل.
وقد يمكن بصورة تقريبية نسبيًا، ولكنها مقربة للغاية، أن تُشبَّه حال العرب في العالم ومصر بين العرب بعد النكسة بحال العالم السلافي وعلى رأسه روسيا بعد حرب اليابان والحرب العالمية الأولى وقبل ثورة أكتوبر، حيث كانت أوروبا تنظر إلى كل منهما كمارد ضخم الجثة راقد على أطرافها وتخومها ولكنه عاجز لا يأخذه أحد بجدية.
وهناك فروق عديدة وجليلة بالطبع، ولكن المقصود فقط هو الموقف العسكري وموازين القوة والهيبة بالنسبة للعالم الخارجي. فالعالم السلافي كان عاملًا كبيرًا واحدًا رغم الاختلافات والخلافات ورغم التعدد السياسي، جميعًا تشده الأصول الأنثروبولوجية إلى حدٍ معين، والقرابة اللغوية إلى حدٍ آخر، ثم كان هناك الدين والكنيسة، وأخيرًا نمط الحياة العامة وقالب الحضارة… إلخ. وفي وسط هذه المجموعة المترامية الممتدة كانت روسيا — بضخامتها وجرمها العملاق ومواردها — تقف تقليديًا وتاريخيًا كحارسة السلافية وحاميتها العتيدة.
ولكن مع تضعضع روسيا القيصرية ثم هزيمتها على يد ألمانيا في الحرب الأولى، بدت كحارسة عاجزة مضروبة ومحتلة مقتطعة أجزاء من أراضيها، لا تملك أن تحمي نفسها فضلًا عن الأخوات الصغريات. إلى أن قامت الثورة، ثم إلى أن كانت الحرب العالمية الثانية حيث بلغت القمة بدورها التاريخي في تحريرهن وحمايتهن. بالمثل كان وضع العرب ومصر في العالم بعد يونيو، بل ربما منذ ١٩٤٨، وسترى بعد قليل كم يصل التشابه إلى منتهاه، وكيف تعادل حرب أكتوبر في أثرها عندنا ثورة أكتوبر عندهم.
وعلى صعيد آخر، فلقد حمل أعداء القومية العربية على فكرة الوحدة العربية، التي لا شك أنها اهتزت بعض الشيء في قرارة النفس العربية، وإن لم يصل الأمر قط إلى حد الشك فيها أو فقدان الإيمان بصحتها أو حتميتها. ولكن الاستعمار انتهزها فرصة للهجوم بالجملة على كل أعمدة العروبة والقومية والوحدة، وذلك للإجهاز عليها مرة واحدة وإلى الأبد. فقد زعموا، على سبيل المثال، أن العرب مجرد مجموعة غير متجانسة: لا عرقًا ولا لغةً ولا لونًا ولا دينًا… إلى آخر تلك النظريات السقيمة الخاطئة التي دفع بها الأعداء بثًّا للبلبلة والتخريب.
ولا مفر لنا من الاعتراف أن هذه الحرب النفسية نجحت نسبيًا في خلخلة التماسك العربي إلى حدٍّ ما، وبدا لوقت ما كما لو أن العرب قد خضعوا لحركة مركزية طاردة (centrifugal) وقعوا في عين دوامتها الكاسحة، وأنهم يتصرفون كما لو كانوا أمة غير واحدة. بل بدا أحيانًا — ولكن فقط على السطح وللمراقب السطحي — كما لو أن العرب ليسوا أصلًا وأساسًا «أمة واحدة»، وأن القومية العربية إن لم تكن مجرد مثالية أسطورية فهي ليست أكثر من حقيقة تاريخية، ولكنها بالتأكيد ليست حقيقة واقعة فعلا… إلخ.
وطنيًا
أخيرًا، على المستوى الوطني، غنيٌّ عن القول إن صدمة النكسة قد هزّت الوجدان الوطني حتى النخاع، وأحدثت مرارة الجرح كثيرًا من التقلصات الحادة بل والتشنجات العنيفة في الجسم السياسي، وأحدثت فجوة تصديق وثقة ساحقة بين القاعدة والقيادة في كل بلدٍ من البلاد العربية تقريبًا. وعلى الجملة فقد انعكست كل تفاعلات الهزيمة على الوحدة الوطنية، وأصبحت مشكلة الوحدة الوطنية هي قضية الجبهة الداخلية الأولية والآنية.
ولحسن الحظ، فإن الوطنيات العربية — بفضل رصيدها التاريخي الزاخر والهائل من التماسك والتجانس والوعي — تجاوزت الأزمة وسرعان ما التئمت جراحها والتحمت صفوفها في وجه الخطر الخارجي. بل لقد اتخذت تلك الوطنيات من الوحدة الوطنية خط دفاعها الأخير الذي تخندقت فيه، أعادت ترتيب بيتها من الداخل واستعدّت للتحدي، ومنه بالفعل قفزت قفزتها التحريرية الرائعة في اللحظة المقدورة.
وفضلًا عن هذا، فلقد سجلت الوحدة الوطنية مكاسب ثورية وتقدمية محققة صنعتها في ظل النكسة وبرغمها، بل وكردِّ فعل متحدٍ ومصل مضاد لها. فكانت الثورة في السودان، ثم في ليبيا، وكذلك في اليمن الجنوبية، ثم في العراق… إلخ. وكان هذا كله إعلانًا بنبذ الهزيمة وبرفض نتائجها، وعلامات على طريق الصمود حتى فجر النصر.
بعث أكتوبر
الآن يأتي السادس من أكتوبر لينسخ هذه الصورة كلها، بل ويقلب التوازنات والأوضاع جميعًا رأسًا على عقب. وكما قال الجنرال بـوڤر:
«إن النجاح العظيم الذي حققه العرب في هجومهم يوم 6 أكتوبر يكمن في أنهم حققوا تأثيرًا سيكولوجيًا هائلًا في معسكر الخصم وفي المجال العالمي الفسيح، ويبقى عليهم بعد ذلك أن يفكروا في نتائج هذا التأثير على العالم ليحصلوا على مناصرته وتأييده».
إنه أول انتصار عسكري حقيقي يحرزه العرب في العصر الحديث، أو كما قالت المجاهدة الجزائرية:
«إن الأمة العربية كلها تحسّ اليوم بفخر عظيم وشكر عميق للجيوش المصرية والسورية التي حققت للعرب أول انتصار لا رجوع فيه. ومهما تكن النتائج النهائية للمعركة، فستبقى حقيقة أنها أنهت مهانة 1967، وجددت الكرامة العربية».
ليس انفعالًا غير منضبط إذن أو تهويلًا غير مسؤول، ولا هو من السابق للأوان كذلك، أن نقول إن السادس من أكتوبر يتجاوز في معناه التحريري والتاريخي ومغزاه النضالي كل أبعاده الراهنة المباشرة، الميدانية منها والديبلوماسية، العسكرية أو السياسية، أو غير ذلك. إنما السادس من أكتوبر هو — بلغة الرسم البياني — «نقطة الانعكاس العنيفة والحاسمة» (point of inflection) في ذلك الخط الخاطئ والاتجاه النازل أبدًا الذي اتخذه منحنى الصراع منذ بدأ في 1948 وحتى الأمس القريب، وإلى أن ينتهي بالتحرير الشامل والاسترداد النهائي للأراضي المحتلة والسليبة والمقدسة على السواء. ومن هنا يشبّهه البعض بحق بمعركة حطين بالنسبة للصليبيات، لم تكن النهاية ولكن بداية النهاية، لم تكن التصفية نفسها هي حطين الصهيونيات. وآخرون يقولون إنها معركة ذي قار في التاريخ العربي.
إن السادس من أكتوبر — نحن نجادل — إنما هو في واقع الأمر الخط الأول في خريطة سياسية جديدة تمامًا للشرق الأوسط وللوطن العربي الكبير، والخطوة الافتتاحية من خطة مستقبلية كاملة عنوانها التصفية والاسترداد والعودة، تصفية الاغتصاب، استرداد فردوس العرب المفقود، وعودة فلسطين — الشعب إلى الوطن والوطن إلى الشعب.
إن تاريخًا جديدًا تمامًا، تاريخًا بكرًا واعدًا مبشِّرًا وواثقًا إلى أقصى حد، قد كُتب ويُكتب حتى الآن بالدماء على الرمال، وإن مستقبلًا جديدًا ليُصنع الآن صنعًا بقوة السلاح وبلا حولٍ إلا به، على أرض سيناء والجولان، ليفرض نفسه فرضًا على أرض إسرائيل المزعومة.
فإذا بدا للبعض في هذا قليلًا أو كثيرًا من التجاوز أو التفاؤل، فلنسمع معًا ما يقوله الآخرون. يقول الكاتب الأمريكي إدوارد شيهان عن أكتوبر:
«إن هذه الحرب لن تُقَيَّم من حيث ما حققته من نتائج عسكرية، بل من حيث إنها نقطة تحوّل تبشر بنهاية عصر التدهور العربي الذي دام أكثر من خمسة قرون».
ثم يضيف:
«هذه الحرب سوف تحتل مكانة في التاريخ العربي المعاصر، بل ربما التاريخ العربي بأكمله. فلقد تكون لها من الوجهة السياسية والمعنوية أهمية تضارع الفتوح العربية الأموية في العصور الوسطى، وهزيمة الصليبيين، ومولد القومية العربية والوطنية المصرية، واسترداد قناة السويس».
أو فلنقرأ ما كتبته «النيوزويك» في دراسة علمية وضعها أخصائيون لا يمكن أن يُتَّهَموا بالانحياز إلى العرب:
«لدى العرب الآن مشروعات تعميرية طموحة، إذا تحولت إلى واقع فقد يكون العرب بالفعل على مشارف عصر نهضة حقيقية».
أو ما كتبته «الديلي تلجراف»:
«لقد غيرت الساعات الست الأولى من يوم 6 أكتوبر مجرى التاريخ بالنسبة للشرق الأوسط كله». أو أخيرًا كما قال كريستوفر ميهيو في شهادة مقتضبة ولكنها جامعة: «لقد غيرت حرب أكتوبر مجرى التاريخ العربي الحديث».
فإذا ما عدنا لنقترب من دقائق الموقف المعاصر وتفاصيله الحية، فماذا بالضبط فعلت المعركة؟ أولًا وقبل كل شيء لقد مزقت حرب أكتوبر ونصر العرب شبكة العلاقات والتوازنات القديمة والقائمة في العالم من حولنا، بكل معطياتها وفرضياتها وقيودها و«نُذُرها»، وبدأ نسيج جديد تمامًا يتخلق بدلًا منها. وفي كلمة اختزالية واحدة، يمكن أن نلخص التغيير الجذري كله في أننا (ومعنا أصدقاؤنا وأنصارنا) قد تبادلنا المواقع والمواقف مع العدو الإسرائيلي (ومعه معسكره والمتواطئون معه) — وطنيًا كان أو قوميًا أو عالميًا.
وطنيًا
فوطنيََا إذا كان لنا أن نبدأ بالدائرة الأصغر، ومن البسيط إلى المركب، فقد فجَّرت الشرارةُ المعركةَ تيارَ الوطنية العارمة، صافيًا، قويًا، غلّابًا. فكان نداء المعركة هو نداء الدم، وكان نداء الدم نداء الوحدة. وفي لحظة تاريخية فذّة تحوّل الجسم السياسي في كل قطر عربي إلى كتلة واحدة صلبة متماسكة كالبنيان المرصوص، ليس بها من الثقوب أو الثغرات إلا ما أصابها من رصاص الميدان، وغير منفذة لرصاص الدعاية العدوة أكثر مما بعد الرصاص منفذًا للماء.
نعم، لقد تلاحمت خيوط الوحدة الوطنية: القاعدة والقيادة، الشعب والجيش، الجبهة الداخلية والميدانية، كما لم يحدث قط من قبل في تاريخ الصراع. فلا شيء في الدنيا — هكذا أثبتت المعركة — كالحرب يستثير الوحدة الوطنية، ولا شيء بعدها كالنصر العسكري يدعم ويقوّي هذه الوحدة. نعم، إن الحرب هي النار التي تصهر الوحدة الوطنية، والنصر هو الأسمنت الذي يلحمها بعد ذلك. أما السبيكة التي صُبّت وصُقِلت فخرجت من المطهَر صافية نقية من كل الشوائب فهي الشعب بكل أصالته، والكل هو في النهاية البوتقة العظمى المقدسة التي نسميها الوطن.
قوميًا
بالمثل قوميًّا. لم تكد الطلقة الأولى في المعركة تدوي حتى انطلقت الأمة العربية بأسرها في مدٍّ قوميٍّ طاغ، أذهل حتى أنفسهم المتمرّسين، حتى أشدهم تفاؤلًا، فضلًا عن الأعداء، هؤلاء الذين لم يشكّوا قط ولم يخطئوا الحسابات في أن قوة العرب في وحدتهم، وضعفهم في تفككهم، وأن قوتهم هم أنفسهم في ضعف العرب وتفككهم فقط، ولا قوة ولا مكان لهم إن اتحد العرب. راجع مثلًا قول دايان: «إن تناقضات الدول العربية سياج أمن يحمي إسرائيل».
وحتى بشهادة الآخرين، فإن انتصار مصر الحاسم في حرب أكتوبر، كما تقول صحيفة «لا سويـس»، وعزل إسرائيل دوليًا، في حين حقق العرب تضامنًا واتحادًا بالفعل والعمل، لا بالأقوال كما كان يتصور البعض خطأ. ومن قبل كتبت «النيوزويك»:
«إن حرب رمضان جاءت بفجائية لا يعادلها سوى الأداء العسكري العربي الممتاز، ووجد ١٠٠ مليون عربي أنفسهم وجهًا لوجه أمام حقيقة عزيزة عليهم هي الوحدة. وأيًا كان، فلقد كان السبب الرئيسي لهذه الوحدة العربية هو يقينًا وقبل كل شيء ذلك النجاح العربي الذي تحقق لهم في ميدان القتال ثم في فرض الحظر على إمدادات البترول».
لقد جاءت المعركة أعظم بوتقة وأدق كشاف لحقيقة العروبة وجوهرها الأصيل، فبرزت القومية العربية حقيقة واقعة، ملء السمع والبصر والوجدان — والميدان أيضًا.
فلقد ألهبت المعركة خيال العروبة، وفجّرت كل طاقتها الكامنة، وجسّدتها قوةً محاربة فدائية واحدة. فتنادت كل الدول العربية إلى ساحة المعركة منذ اللحظة الأولى، وألقت كل منها بكل مواردها وإمكانياتها وثقلها في الميدان: رجالًا وسلاحًا، مالًا وبترولًا. تلاشت كل الحساسيات والحسابات القديمة، وانفكت العقد الوهمية والتحفّظات، تقاربت كل الأنظمة والمذاهب، ذابت دول المساندة في دول المجابهة، وانصبّ المغرب في المشرق. (راجع، على سبيل المثال فقط، ما قالته «النيوزويك» من أنهم الآن في لبنان يقولون إنهم عرب، بينما كانوا قبل 6 أكتوبر يتحدثون عن الفينيقية).
وبهذا أيضًا توسعت حركة التحرير الوطني مع معركة التحرير الوطني جغرافيًا، نضاليًا، وفكريًا، لتتحول من مجرد «أزمة الشرق الأوسط» (اللغانتية) إلى قضية العروبة بأسرها من المحيط إلى الخليج. وفي هذا الإطار برزت ليبيا وهي عمق استراتيجي فعّال ومثمر جدًا لمصر — بالسلاح والمال والبترول كوقود وكطريق وكميناء بديل آمن.
ومثلما برز العراق عملًا استراتيجيًا ضخمًا ومساندًا مقتدرًا لسوريا، ليس فقط بتأمين ظهرها وظهيرها وفتح طريقها، ولكن أولًا وقبل كل شيء بسلاحه ورجاله. وكما قدّمت السعودية مشاركة بترولية ومادية ومعنوية عظيمة، سياسيًا وماليًا، بل وسلاحًا وجنودًا، قامت الجزائر الثائرة بدور أكثر من رائع عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا. كذلك فعلت بقية دول المغرب، ومن قبلها الكويت ودولة الإمارات العربية وسائر دول الخليج. وبالمثل قدّمت اليمن الشعبية والشمالية معاونة استراتيجية قيمة في حصار باب المندب بحريًا.
ومن الناحية المادية البحتة — على سبيل المثال فقط — إذا كانت دولتَا المواجهة قد صبّتا في المعركة ما لا يقل بحال عن العشرة آلاف مليون جنيه عبر سنوات الإعداد، فقد شاركت دول المساندة بنصيب كبير في دعمها قدّره بعض المصادر الخارجية بنحو الثلاثة بلايين دولار، فضلًا عن بليون رابعة بعد ذلك.
لقد اندغم الجميع في جبهة حرب واحدة طولها القومية وعرضها الوحدة، وتحققت جماعية القيادة، وبدأ قادة العرب كما لو كانوا «فرسان المائدة المستديرة». وبعد أن كنا نعيش — أو نعاني — «معركة القومية»، عايشنا «قومية المعركة». في الجبهة السورية كانت القوات العراقية والمغربية والسعودية ثم الأردنية تحارب مع الجيوش السورية المستبدلة والقوات الفلسطينية الفدائية. وفي الجبهة المصرية شارك السلاح الجزائري والليبي، فضلًا عن قوات رمزية من السودان والكويت والمغرب… إلخ. حتى بعض الدول العربية وزّعت قواتها الرمزية على كلتا الجبهتين. إنها وحدة الدم تختلط بوحدة التراب على خط النار.
وخارج جبهة القتال وإلى جانبها، فُتحت جبهة البترول. فبدأت دول البترول العربية حربًا حقيقية — حرب البترول — بإرادة ذاتية ودون ضغوط من الأشقاء. بدأتْها فكانت عونًا لنا، وعونًا على الأعداء وأنصاف الأعداء، وأرباحًا على الأصدقاء من أدعياء الحياد واللامبالين أو المتعاطفين مع العدو سرًا، ألسنتهم مع العرب وأسلحتهم مع العدو. ولا زالت المعركة مستمرة، وهي إذا كانت تحتاج وحدها إلى وقفة خاصة مفصلة، فإن ما يعنينا منها هنا هو مغزاها القومي الكبير العام: ما معناها؟ وما معنى وحدة العمل العربي؟ علامَ يدل هذا كله؟ وإلى أين يؤدي؟
بغير مقدمات مطوّلة، هناك ثلاثة معانٍ، أولًا، إن القومية العربية حقيقة واقعة ارتفعت إلى مستوى المعركة مثلما ردّت هذه لها اعتبارها. لقد أعادت المعركة خلق العالم العربي، وخلقت منه عالمًا جديدًا شجاعًا. الحرب أثبتت وحدة العرب، وحققت للعرب وحدة الحرب، وهي وحدة عسكرية وسياسية، وأيضًا اقتصادية وإعلامية، أي وحدة واقعية تتجاوز كل مشاكل الوحدة الدستورية، ولكنها تكاد تتجاوزها عمليًا في التنسيق والتضامن والتنظيم. وعلى هذا الأساس تقدّم التفاعل العربي في ظل المعركة، كما لوحظ: من وفاق عربي إلى تضامن عربي إلى وحدة عربية. ومن بين الكل خرجت القوة الذاتية العربية، وهي القاعدة الأساسية والأصولية في المعركة والصراع جميعًا.
ولقد تجلى هذا — بالمناسبة — أبلغ ما تجلّى في مؤتمر القمة بالجزائر، أول مؤتمر عربي منتصر منذ بدأت مؤتمرات القمة، وأول مؤتمر ناجح لا فاشل، هجومي لا دفاعي. كذلك بدا الوطن الكبير أثناء المعركة وبعدها، ولكن أساسًا من خلالها، أشبه بـ«كومنولث عربي» تلقائي، وربما قال البعض «اتحادًا كونفدراليًا» دون الاسم والشكل.
ولا ينفي هذا بطبيعة الحال وجود بعض صعوبات واختلافات، إلا أنها ثانوية وعارضة وضعتها المعركة على الرف مؤجّلة أو مجمّدة. ولا شك كذلك أنها ظاهرة ذات دلالة عامة أن جامعة الدول العربية قد بدأت مؤخرًا مراجعة نظامها الأساسي والتفكير جديًا في تعديل وتطوير كيانها إلى مستوى أعلى يتلاءم مع التطورات الضخمة التي أحدثتها المعركة في الصف العربي.
المعنى الثاني للموقف العربي أن البترول أثبت نفسه سلاحًا سياسيًا من الدرجة الأولى، وسلاحًا قوميًّا في الدرجة الأولى. لقد نجحت المعركة نهائيًا في تسييس البترول بعد أن كان ذلك أملًا بعيدًا، بل مستبعدًا جدًا في نظر البعض، وقد تحقق هذا بفضل جهود دائبة وصامتة في مجال العلاقات الثنائية.
وبطبيعة الحال فلقد كانت هنا أيضًا صعوبات ومشاق في التخطيط والتنسيق والتنفيذ، ولكنها كلها توارت خلف الدفع القومي الباهر. ومن الواضح أن سلاح البترول لم يكن ليسبق منطقيًا وعمليًا السلاح العسكري، بل كان لابد للأخير أن ينطلق ويعمل قبل أن يشرع الأول ليعمل على الفور. لقد كان توزيع الأدوار هنا أيضًا بحسب ترتيبها، وهكذا بالفعل كان.
ويبقى أخيرًا معنى ثالث لا يقل دلالة وخطرًا، لقد مارست مصر دورها الطبيعي والطليعي في قيادة الصراع وأدارته بالعمل الهادئ الفاعل، وبإنكار الذات دون ادعاء فظٍّ غليظٍ منفِّر. فمصر، التي قدّمت نحو 100 ألف شهيد وأنفقت نحو 10 آلاف مليون جنيه على مدى 25 سنة منذ بدأ الصراع العربي – الإسرائيلي، حشدت في معركة أكتوبر وحدها 101 مليون جندي تحت السلاح لمواجهة كل الاحتمالات. وهذا بالتأكيد أضخم حشد عسكري محلي عرفته منطقة الشرق الأوسط في تاريخها الحديث وربما القديم.
وبهذا العطاء الذي لا حد له، ارتفعت إلى مسؤوليتها التاريخية كقلعة العروبة، واضعة قدرها على كتفها وقلبها على يدها، فالتف العرب حولها مبايعين مزكّين، واستعادت هي حجمها الطبيعي بينهم — ثلث العرب — واستردّت مكانتها التي اهتزت حينًا بالهزيمة، وفي الوقت نفسه وفّرت لكل منهم دورًا مشرّفًا وبنّاء.
لقد كانت معركة أكتوبر بالنسبة لمصر بين العرب كثورة أكتوبر بالنسبة للاتحاد السوفيتي بين السلاف، وخرجت منها وهي «روسيا العرب»، لا و«بروسيا العرب» كما كان الاستعمار يزعم ويردّد تمزيقًا وتأليبًا. ومن الناحية الأخرى أثبتت مصر 6 أكتوبر أن الزعامة السياسية الحصيفة الرشيدة إنما هي فن توزيع الأدوار، لا احتكار الأدوار، هي «أولوية بين أكفاء» (inter pares)…
عالميًا
إذا انتقلنا أخيرًا إلى المستوى العالمي، فماذا فعل 6 أكتوبر بالعرب والعالم؟ أولُ شيءٍ أن الحرب كشفت عن مفاجأة مذهلة، نحن أقوى مما كنا نحنُ نظن، ومما كان أعداؤنا يتصوّرون، بل وكذلك أصدقاؤنا. في ساعاتٍ انهارت كلُّ الأفكار المسبقة المُهَيَّأة والنظريات المشبوهة الموضوعة (وغير الموضوعة) للتشويه وتحطيم العالم العربي سياسيًا ومعنويًا ونفسيًا ودعائيًا، ثم في أيامٍ فقط كانت الصورة كلها قد انقلبت بطنًا لظهر. ونستطيع هنا أن نقسم دراستنا إلى عنصرين: الإنسان العربي والسياسة العربية، أو المقاتل العربي والدولة العربية.
الإنسان العربي المقاتل
فقد كان أول ما أثبتته المعركة أن الإنسان العربي مقاتل، مقاتلٌ ممتاز، شعبٌ محارب قادرٌ على قبول التحدي وعلى تحدي العصر. وفي الوقت نفسه نَسَفَت كلُّ دعايات العدوّ المغرضة عن الشعب غير المحارب والجندي الذي لا يجيد إلا الفرار عند أول مواجهة والإنسان غير القابل للتعليم وغير القادر على استيعاب فنون الحرب الحديثة… إلخ.
لقد أعادت المعركة ثقةَ الإنسان العربي بنفسه كمحارب، وأعادت تقديرَ العالم واحترامه له عسكريًا، كما أعادت بعثَ العسكرية العربية في أشرف صورها وأكثرها إشراقًا. وفي هذا قالت «التايمز» إن العرب حققوا الانتصار، وبرهنوا على أن قواتهم تستطيع أن تقاتل وأن تستخدم الأسلحة المعقّدة بنجاح كبير، كما أن القادة العرب أثبتوا أنهم يقودون ببراعة… بل وكما اعترف عالمُ نفسٍ إسرائيلي:
«لم يَعْبُرِ العربُ السويسَ فقط، بل إنهم حاربوا جيدًا أيضًا ولم يَقِرّوا. وقد بدّدوا الادعاءَ الإسرائيلي بأنه لا يمكن لأيّ قدرٍ من العلم أن يُحَسِّن قتالَ العرب».
لقد تذكّر العالم فجأة — كما قالت صحيفةٌ غربية — أن العرب فتحوا أوروبا من قبل، وغزوا العالم، وأسسوا إمبراطوريات، وهزموا الأتراك وهددوا الأستانة…
ومن زاوية القدرة التكنولوجية، لدينا أكثرُ من شهادةٍ لمحايدين وغيرِ محايدين. فقد كتب درو ميدلتون:
«لقد أكدت عمليةُ العبور المصرية للقناة أن تلك القوات قد تطوّرت تكنولوجيًا منذ 1967، وأثبتت تلك العملية أن المصريين قادرون على الإبقاء على السر، وأن في وُسعهم — بعد ما حققوا من مفاجأةٍ ونجاح — أن يتصرّفوا في انضباط».
كما أضاف أن جميع التقارير التي وصلت إلى مصادر غربية تشير إلى أن الجيوش العربية تقاتل بعنادٍ وحماسة، وأن القيادة على مستوى الكتائب والأسراب من مستوى مرتفع، كما كانت القيادة العامة تُقَدِّم بالفطنة والحكمة.
وبينما قالت «الأوبزرفر»:
«منذ عامٍ أو عامين كانت إسرائيل تبدو متقدمةً في سباق التكنولوجيا العسكرية… وقد تنبّه المصريون — فيما يبدو، خلال حرب الاستنزاف عام 1969 — إلى أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في القتال… ويبدو الآن، وبعد معارك أكتوبر 1973، أن مصر قد لحقت بإسرائيل وسبقتها تكنولوجيًا في ميدان الصواريخ والإلكترونيات».
وبصيغة حاسمة أيضًا قالت «الجارديان»:
«لقد بَرهن الجيشان المصري والسوري على أنهما أفضل تدريبًا وأحسنُ تشكيلًا واستعدادًا وأشدُّ جَلَدًا وأفضلُ عِنادًا».
أمّا «النيوزويك» فقد كتبت في نهاية الحرب قائلةً إن الروح القتالية العالية والأسلحة الحديثة لدى الجيش المصري كانتا وراء الخسائر العالية في الأرواح التي يصعب على إسرائيل تحمّلها، فضلًا عن أنها أفقدتها توازنَها… ثم أضافت أن الشراسة العربية في القتال لم تُقَدَّر حقَّ قدرها منذ بداية الحرب، كما أن وجود عدد كبير من الكفاءات العربية وراء خطوط القتال جعل من المستحيل أن يتعرّض العرب لنقصٍ في الرجال.
وحتى ثقةُ الإسرائيليين في أن لديهم تفوقًا تكنولوجيًا واضحًا على العرب في مجال السلاح قد سقطت؛ مثل الطائرات، بفعل النجاح العربي الملحوظ في استخدام الأسلحة المضادّة للطائرات والدبابات.
حتى العدوّ نفسه اعترف؛ مثلًا آري يعري، عضو «المايام» الإسرائيلي، قال إن حرب أكتوبر — بمدّتها ومعاركها وعدد ضحاياها — قد أثبتت مدى التقدّم الكبير الذي أحرزته القوات العربية وقدرةَ مقاتليها على استخدام الأسلحة الحديثة المتطورة والمعقّدة. هذا بينما كتبت «معاريف» — في حقدٍ ولوعة —: «لقد سبقت السلحفاةُ العربيةُ الأرنبَ الصهيوني».
حتى قادةُ العدو لم يملكوا إلا أن يعترفوا: «كان الجندي المصري يتقدّم في موجاتٍ بعد موجات، وكنا نُطلِق عليه النار وهو يتقدّم، نُحيل ما حوله إلى جحيمٍ ويظل يتقدّم، وكان لونُ القناة مُخَضَّبًا بلون الدم، ومع ذلك ظل يتقدّم» — هكذا تكلّم جونين مهندسُ الهزيمة المباشر.
أمّا من خلف الخطوط فقد جاء صوتُ الجنرال أوزي تاركيس — المشهور بتعليقاته العسكرية — ليُسَلِّم «بأنه لا مفرّ من أن تُشْهَد لجهاز التخطيط المصري بالبراعة. لقد كانت خططُهم دقيقةً، وتنفيذُها أكثر دقّة. ولقد حاولنا جهدَنا إعاقةَ عملية العبور وردَّها بالقوة على أعقابها، غير أننا ما كدنا نتمثّل ما حدث إلا وكانت نتائجه قد تحقّقت لهم، كأنما أَغْضَضْنا أعينَنا وفتحناها فإذا هم قد انتقلوا — تحت النار — من غرب القناة إلى شرقها، وفاجأونا صباح ٧ أكتوبر بخمسِ فِرَقٍ كاملة أمامنا على الضفة الشرقية من القناة».
وأخيرًا هناك اعتراف آلون: «ليس هناك وجهٌ للمقارنة بين المعارك التي خاضها المصريون في أكتوبر والمعارك التي خاضوها من قبل، حيث كان واضحًا حرصُهم على عدم تكرار الأخطاء السابقة، إلى حد أن كلمة الانسحاب اختفت تمامًا من القاموس المصري».
أمّا من المحايدين فإن الجنرال «يوفر» يُلَخِّص لنا الموقفَ كله في جملةٍ مُركّزة ولكنها جامعة: «لقد دخل العربُ مدرسةَ الحرب الحديثة، وبنجاح». وفي مناسبةٍ أخرى تراه يقول — في شهادة واقعية بعد زيارة ميدان المعركة وما رآه حوله —: «إن العرب قد حاربوا بأكفأ مستوى يعرفه العصر».
والواقع أن تجربةَ المعركة أثبتت أن التفوّق الكمّي العربي آخذٌ في التحوّل تدريجيًا إلى تفوّقٍ كيفيٍّ أيضًا، وأن التفوقين — هذا وذاك — هما بِسَبيلهما إلى الانتقال نهائيًا إلى العرب.
أو كما قال دافيد إليعازر: «لقد فوجئ الجيشُ الإسرائيلي بأن الكمَّ المصري قد تحوّل إلى كيف». وفي هذا أيضًا كتب آري يعري يقول إن التقدّم العربي في «الكيف» يُضاف إلى المزايا الهائلة التي يتمتع بها العربُ من حيث «الكم»، ثم ينتهي إلى أن هذا يدعو إلى تغيير النظرية القائلة بأن إسرائيل يمكنها — بتفوّقها في الكيف — أن تضرب العربَ في كل جولةٍ جديدة.
وأخيرًا يصل بنا أحدُ المعلّقين العسكريين البارزين في الغرب إلى قمة الشهادة — وكذلك منتهى النبوءة — فيقول: «إن الطريقة التي حارب بها الجنديُّ العربي في ١٩٧٣ ضربت التفوّقَ الإسرائيلي المطلق، وتلك كانت واحدةً من كبرى حقائق الجولة الرابعة بين العرب وإسرائيل. وهي — على هذا الأساس — نذيرُ شؤمٍ لإسرائيل في الجولة الخامسة، ونذيرُ كارثةٍ في السادسة، وقد تكون نهايةَ كلِّ شيءٍ في السابعة».
والخلاصة التي يمكن أن تخرج بها من كل هذه الشهادات والمؤشرات هي أن المعركة قد أثبتت — أولًا وآخرَ وأخطرَ ما أثبتت — الروحَ القتالية العالية المُندفعة الكامنة في الجندي العربي، وأكدت فدائيةَ المقاتل العربي واستبسالَه وإقدامَه بلا تردّد، لا ينكص ولا يتراجع عن تحقيق هدفه مهما كان السلاحُ الذي يواجهه. ليس هذا فحسب، إذ قد أثبتت المعركة أيضًا قدرةَ المقاتل العربي على استيعاب أعقدِ الأسلحة الحديثة والمتطورة والسيطرة عليها بكل كفاءةٍ واقتدار، وتطويعَ التكنولوجيا وتكييفَها والتكيّفَ معها، والتعاملَ بها على كل المستويات. كذلك الأمرُ مع فنون القتال: التخطيط، التنفيذ، المناورة، والحركة… إلخ
فعلى سبيل المثال، أثبتت المعركةُ خطأَ الاتهام الذي روّجه العدوُّ عنا من أن العرب لا يُجيدون القتالَ إلا من المواقع الثابتة؛ فأكّدت للعالم تقدُّمَهم — بنجاحٍ تام — من القتال الثابت إلى القتال المتحرك. كذلك أثبتت قدرةَ الدبابات المصرية والسورية المتفوّقة على القتال الليلي — على عكس الجولات السابقة — وبالمثل سلاحُ المشاة المصري، بينما يَشُقّ على مشاة إسرائيل الاشتراكُ في أي قتالٍ ليلي تقريبًا رغم تدريبهم عليه.
وفي هذا كله وغيره، نَسَخَتِ الحربُ — ونَسَفَت إلى الأبد — كلَّ الأساطير والدعايات المُشوَّهَة، الظالمة والكاذبة، التي ركّز العدوُّ عليها كلَّ جهدِه وأبواقِه لإلصاقها بالمقاتل العربي ونوعيّته، أوّلًا لتثبيتها في نفسِه هو، ثم ثانيًا لترسيخها في عقلية العالم.
أو كما عبّر كاتبٌ أوروبي كبيرٌ بقلقٍ أكبر: «إن ما هو خطيرٌ في تدمير خط بارليف وحصون الجولان ليس تحريرَ جزءٍ من التراب العربي المحتلّ، وإنما هو في تدمير صورةٍ ثابتةٍ عن الإنسان العربي كانت رائجةً عندنا». فتلك الأساطيرُ والأكاذيب، التي استخرجها العدوُّ من تجارب الماضي
ودلّل عليها بها، لم تكن تقوم على أي أساسٍ من الحقيقة أو الواقع — كما يدرك هو في قرارة نفسه — فكلُّ تجارب الماضي لم تكن اختبارًا لقدرة وطبيعة المقاتل العربي كفردٍ أو كمجموعةٍ بقدر ما كانت تسجيلًا لأخطاءِ القيادات المهزوزة غير الناضجة أو غير المؤهلة.
فمن الثابت المقرّر — كما عبّر أحدُ كبار العسكريين المصريين أثناء أكتوبر — أن حرب ١٩٤٨ كان فيها فقط بعضُ المواجهة، وحرب ١٩٥٦ قليلٌ من المواجهة، وحرب ١٩٦٧ لا مواجهةَ تقريبًا… الحربُ الرابعة وحدها كانت أولَ اختبارٍ حقيقيٍّ ميدانيٍّ حاسمٍ لنوعية المقاتل المصري والسوري كجنديٍّ محارب. وفي هذا الاختبار الأول، بقدر ما تحطّمت خرافةُ «العسكرية الإسرائيلية» وانكشفت حقيقةُ المقاتل الصهيوني، بقدر ما أثبت هو نفسه وجودَه وتفوّقَه بلا حدود. أو كما قال مُعلّقٌ عسكريٌّ غربي: استردَّ اعتبارَه وشرفَه العسكري؛ وهذا تطوّرٌ بالغُ الخطورة والدلالة، له ما بعده في المستقبل — مستقبل الشرق الأوسط كله.
حتى العدوُّ نفسه تغيّرت نظرتُه إلى الإنسان العربي والمقاتل العربي، واعترف — أو كما ذكر تيرنس سميث — بأن الإسرائيليين، من الجندي الذي يقف على خط النار إلى الوزير في الحكومة، ينظرون إلى العرب نظرةً مختلفةً بعد حرب رمضان. أو كما كتب أريك رولو: إن الإسرائيليين ما عادوا يستخدمون التعبير العبري الشائع «أرافيت زي أرافيت» (أي: «العربي لا يعدو أن يكون عربيًا») الذي يمثّل قمةَ التهوين من شأن العرب بل والتحقير لهم، وأصبحوا الآن يقولون:
«لقد أجبرنا العربُ بالقوة على احترامهم. إننا نعرف الآن أن في استطاعتهم أن يكونوا على نفس القدر من الشجاعة، وأن في إمكانهم استيعاب الفنون العسكرية الحديثة».
بل الواقع أن من أطرف نتائج أكتوبر وأكثرها مدعاةً للتفكير أن العدوَّ نفسَه لم يَعترف فقط بكفاءةِ وبسالةِ المحارب العربي في تلك الحرب، ولكن أيضًا — بأثرٍ رجعيٍّ — على حروب الماضي! لقد «أعاد اكتشاف» حقيقةَ معدنِ المقاتل والإنسان العربي متأخرًا ربعَ قرن. (انظر مثلًا ما كتبه الجنرال متتياهو بيلِيد في «معاريف»): «من الواضح حتى الآن أن الجنديَّ المصري يُظهر روحًا قتاليةً قوية، ولم يفقد إرادتَه على مواصلة القتال. إننا نعرف هذه الظاهرة جيدًا منذ حرب ١٩٤٨، وخلال حرب سيناء كذلك في ١٩٥٦. لم تكن قليلةً الحالاتُ التي حارب فيها الجنديُّ المصري حربًا عنيدة — في المعارك الدفاعية. وفي جميع الحالات كان المصري موجودًا في تجهيزاتٍ محميةٍ يُحْسِنُها، ولم يُفاجَأ بالهجوم عليه، وإذا لم يحدث انهيارٌ في الجيش، ولم تتولّد ظروفٌ جديدة لا يُلِمُّ بها إلمامًا تامًّا، فإنه سيستمر في تنفيذ مهمته بإخلاص، وهذا ما يحدث الآن في جبهة القناة».
أو انظر إلى ما كتبه المدعو تِدِّي برديس في «دافار»: «إن الثغرة بين التوقعات والواقع الذي نشأ هذه المرة تَكْمُن في الحقيقة التي نسيناها، وهي أن العربي لم يكن — خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية — مقاتلًا رديئًا، بل قاتل بشجاعةٍ وتصميم. إلا أن أصحاب شعار «وهذه ليست لعبتهم» طمسوا هذه الحقيقة وشوّهوها. كذلك فإنهم تناسَوا نتائجَ الأبحاث السيكولوجية على الأسرى المصريين ١٩٦٧، تلك التي كانت بعيدةً تمامًا عن الاستخفاف بالجندي المصري، الذي وُجد أنه يتمتّع بقوةِ تحمّلٍ كبيرة، وكفاءةٍ جسميّةٍ جيدة، وروحٍ هجومية».
ثم عدد الكاتبُ حالاتٍ من الصمود المصري النادر — نُسِبَتْ، بسبب أقوال العجرفة والتعالي التي كانت تصدر عن القادة والسياسيين —: جيب الفالوجا ١٩٤٨ نموذجًا؛ قوةُ صمود المصريين في «أبو عُجيلة» ١٩٥٦، حيث اضطر الجيشُ الإسرائيلي إلى العمل ثلاثةَ أيامٍ لاختراقهم (١٠٠ ساعة في الوحل)؛ شجاعةُ ومهارةُ المصريين في الإغلاق المتتالي للثغرات التي كانت قوةٌ إسرائيليةٌ مختارةٌ تحاول شقَّها على مفترق طرق رفح في ١٩٦٧… إلخ.
الدولة والسياسة العربية
ذلك كله عن الإنسان العربي كرجلٍ محارب بين إنسان العالم. أمّا من الناحية السياسية العالمية فإن الانقلاب لا يقلّ خطرًا ولا مغزى، وهو في الواقع مترتّب مباشرةً على الانقلاب الحربي. فلأوّل مرة خرج عربُ ٦ أكتوبر وهم «صُنْعةُ التاريخ» بعد أن ظلّوا طويلًا «لُعبةَ التاريخ»، وتحولت المنطقة من منخفضٍ سياسيٍّ إلى منطقةِ ضغطٍ سياسيٍّ مرتفعٍ مؤثّرٍ وفعّال، ومن إقليمٍ جيوبوليتيكيٍّ سالبٍ إلى إقليمٍ موجبٍ يساهم اليومَ جِدّيًا في تشكيل التوازن العالمي وتضاريس السياسة الدولية.
باختصار، أصبح العالمُ العربي فاعلًا بعد أن كان مفعولًا به بانتظام، أو مجردَ ردِّ فعلٍ على أفضل تقدير. ولأول مرة في تاريخها الحديث قريبًا، أصبح العالمُ العربي عاملًا هامًّا في تحقيق التوازن السياسي في المنطقة — إن لم يكن الأساسي، ولا نقول الوحيد. ولأول مرة يصبح مصيرُ المنطقة معلّقًا بقواها الداخلية وإرادتها الذاتية أكثرَ ممّا هو متعاطٍ أو مرتبطٌ بعواملَ وقوى من خارجها. ولأول مرة كفّ العالمُ العربي عن أن يكون «لعبةَ السياسة الدولية» المفضّلة، بما في ذلك الاستقطاب أو الوفاق. وعدا ذلك تمّ تصحيح ميزان القوة الذي كان قد اختلّ بوضوحٍ في غرب آسيا، ووُضع حدٌّ للاستراتيجيات الإقليمية المضادّة فيها، بل لقد غيّرت المعركةُ ميزانَ القوة في قارة آسيا عمومًا.
ليست إسرائيل وحدها إذن التي رُدَّت إلى حجمها الطبيعي؛ العربُ أيضًا، بل العربُ أكثر — والأكثرُ في المستقبل. لقد انقلبت كفّتَا الميزان بينهما، أو بالأصح عادتا فاعتدَلَنا وصَحَّحْنا. وكما قالت جريدة «المجلة» مؤخرًا: «شيءٌ واحدٌ مؤكّدٌ الآن: إن العرب أصبحوا في الوقت الحاضر في مركزٍ تفاوضيٍّ أقوى بكثيرٍ مما كانوا عليه… وإن إسرائيل قد أصبحت في مركزٍ أسوأ بكثيرٍ ممّا كان العربُ — أو أحدٌ — يعتقده ممكنًا قبل بداية الحرب…».
وحتى أولئك الذين يُشكّكون في النصر العسكري العربي أو يقلقون منه، لا يملكون أن يشكّكوا في نتائجه العالمية السياسية والنفسية أو أن يقلّلوا منها. مثلًا كتبت مجلة «تايم» في حديثٍ لها مع الرئيس المصري: «إن المؤرخين سوف يتجادلون طويلًا حول ما إذا كانت الجيوش المصرية قد أحرزت بالفعل انتصارًا عسكريًا في حرب أكتوبر. ولكنهم — على الأرجح — لن يختلفوا حول الرأي القائل بأن نتائجَ الحرب قد أعادت للعالم العربي قدرًا من الثقة بالنفس كانوا في أشدّ الحاجة إليه، وكان غائبًا عنهم منذ الهزيمة المهينة عام ١٩٦٧».
وليس أدلَّ على الهيبة الدولية الجديدة والمكانة المرموقة التي حقّقها عربُ أكتوبر من نظرة العالم الجديدة إليهم. فبدل الإشفاق والرثاء الممزوج بالاستخفاف — إن لم يكن ما هو أسوأ — حلّ الاحترامُ والتقديرُ الذي لا يخلو أيضًا من إعجاب. أو كما ذكرت «ورقةُ أكتوبر»:
«لقد رفعت حربُ أكتوبر من شأن العرب جميعًا، وأصبح العالمُ كلُّه يعترف بالوجود العربي وبِدَور العرب ويعمل على كسب ودّهم».
أو كما كتبت «النيوزويك»: «الزمن تغيّر فجأة. تبدّلت نظرةُ العالم إلى العرب، وأصبح ينظر إليهم بكل الجِدّية، بعد طول معاملةٍ لهم على أنهم شعوبٌ همجيةٌ ودولٌ متخلّفة. وبالمثل بدأ العرب ينظرون إلى أنفسهم على ضوءٍ جديد». بل إن قطاعًا كبيرًا من العالم — وخاصةً من العالم الثالث — أصبح يتطلّع إلى العرب ويرنو ساعيًا إلى التقارب معهم.
وعَدَا هذا فلا يكاد يمضي يومٌ منذ أكتوبر دون أن يزور سياسيٌّ قياديٌّ أو وفدٌ كبير من دولةٍ ما من دول العالم دولةً عربيةً أو أخرى، بينما تتجوّل الوفود العربية بدورها بكثافةٍ على اتساع العالم تُلْقَى بالترحيب والاحترام. أمّا عُروضُ القروضِ والمعوناتِ ومشاريعُ التنمية والمشاركةُ في التعمير فلا تكفّ عن التدفّق تباعًا من كلّ الجهات.
وهذا كلُّه صورةٌ مرآويةٌ مقلوبةٌ أخرى لما حدث في أعقاب يونيو، حين كان الكلُّ في زيارةِ المنتصرين، وكانت الأموال تنهالُ على إسرائيل بغير حساب… لقد أصبح العالمُ العربي — بوضوح — بؤرةَ اهتمامِ العالم ومحطَّ أنظاره كقوةٍ ضاغطةٍ مؤثّرةٍ فيه لها وزنُها وتقديرُها، وورث العربُ مكانَ إسرائيل السابق في قلب العالم وعقله.
وحسبُنا في هذا الصدد أن نشير — مثلًا — إلى مؤتمر القمّة الإسلامي الثاني الذي عُقد في لاهور أخيرًا تقديرًا ومساندةً من العالم الإسلامي لقلبه العربي. فعلى العكس من المؤتمر الأول الذي عُقد في الرباط منذ أربع سنواتٍ في ظلّ الهزيمة، جاء المؤتمرُ في ظلّ النصر فكان نجاحًا كاملًا. وكما جاء المؤتمرُ دفعةً معنويةً كبيرةً للعرب كان تأكيدًا لانتصارهم ولنُفوذهم المتعاظم في العالم بعد النصر. وبالمثل كان دورُ العرب — وخاصةً مصر — في تحقيق التصالح والتقارب بين الباكستان وبنغلادش داخل المؤتمر دليلًا على مكانتهم المرموقة في العالم الإسلامي.
وعلى الجانب الآخر — جانبِ العدو — جاء المؤتمرُ ضربةً سياسيةً أخرى ومزيدًا من الحصار. اقرأ مثلًا ما كتبته «هاتسوفيه» صحيفةُ الحزب القومي الديني في إسرائيل: «إن نداءَ تحرير القدس الذي وجّهه مؤتمرُ لاهور يأتي في وقتٍ أصبح العالمُ الإسلامي فيه أقوى من الناحيتين السياسية والاقتصادية بصورةٍ لم تحدث منذ أربع سنوات» (حين عُقد مؤتمر الرباط). أو اقرأ ما كتبته «معاريف»:
«لقد أوضح مؤتمرُ لاهور تمامًا التناقضَ بين الواقع الذي يحيط بنا والواقع الذي نعيش فيه، وبين الوحدةِ المُتزايدة للعالم العربي والفرقةِ التي تُنهكنا».
ليس هذا فحسب، بل إن العالمَ العربيّ نفسَه «يتوسّع» الآن بصورةٍ لافتةٍ لا يمكن أن تكون بلا مغزى. فليس من الصدفة وحدها — على الأرجح — أن يتمّ انضمامُ دولتين من أفريقيا، موريتانيا والصومال، إلى «الجامعة العربية» في وقتٍ واحدٍ تقريبًا قبيلَ وبعدَ انتصار أكتوبر مباشرةً، كأنها جميعًا على ميعاد. لقد اتّسعت جغرافيةُ العروبة كما ارتفعت قامتُها.
ويسترعي الانتباه هنا — كما يستدعي التفسير بإلحاح — أن تنبثق كلُّ هذه الانطلاقة والطفرة الإيجابية من أمّةٍ قيل عنها بالأمس فقط إنها قد أُصيبت بتصلّب الشرايين، إن لم يكن بالشيخوخة المبكّرة أو القديمة.
فكيف نُفَسِّر هذه المتناقضة — إذا كانت صحيحة — وإنْ صَحَّت فإلى أيّ حدّ؟ وما هو التشخيص أو التكييف العلمي الدقيق لهذا التطوّر؟ الإجابةُ تكمن في «دورة الحياة الجيوبوليتيكية» كما وضعها العالمُ الجغرافي «فان فالنكنبرج»، تلك التي تُحدِّد مراحلَ تطوّر الدولة كجسمٍ سياسيٍّ وككائنٍ عضوي — بمعنًى ما — في أربع: مرحلةُ النشأة أو الطفولة التي تنطوي فيها الدولةُ على نفسها تُرتِّب بيتها من الداخل وتحمي حدودها في الخارج، ثم مرحلةُ الشباب أو التوسّع وفيها تنطلق إلى دورٍ خارجيٍّ إيجابيٍّ إمّا من التوسّع أو فرضِ النفوذ، ثم مرحلةُ النضج أو الاستقرار حين تكون قد وصلت إلى أوجِ القوة ولا تريد إلّا المحافظةَ على الوضع الراهن والتوازنات القائمة، ثم أخيرًا مرحلةُ الشيخوخة أو الانهيار التي تعجز فيها عن المحافظة على نفوذها أو حدودها فتبدأ تفقد منها تدريجيًا حتى تنكمشَ وتتقلّص — وربما سقطت — لتقوم دولةٌ جديدة تبدأ دورةً جديدة… وهكذا.
والدولُ العربية كنُظُمٍ سياسيةٍ معاصرة تُعتبر — ابتداءً — دولًا حديثةً في مرحلة النشأة، لأنّها — رغم عراقتها التاريخية الألفيّة — إنما بدأتْ دورةً جيوبوليتيكيةً جديدة بالأمس القريب فقط حين تحرّرت من الاستعمار الأوروبي واستكملت استقلالَها النهائي منذ عشرين سنةً أو عشرِ سنواتٍ على الأكثر — أو في المتوسّط.
وبعضُ هذه الدول كمصر وسوريا والعراق كان يزحف حثيثًا نحو مرحلة الشباب وقد انطلق بالثورة والتنمية، والبعضُ الآخر كان على الطريق بفضل ثورة البترول وثروته الدافقة كالسعودية وربّما الجزائر وليبيا… إلخ. ولكن هزيمةَ يونيو ردّت أكثرَ هذه الدول إلى الخلف كثيرًا، رغم أنه كان وضعًا مؤقتًا مُعلّقًا بالضرورة.
وهنا يأتي دورُ أكتوبر: إنه — بالدقة والتحديد — قد جدَّد شبابَ العرب جميعًا، وبدأ مرحلةً جديدةً من تجديد شباب الدول العربية (Political rejuvenation)، وخاصةً منها دول المواجهة والطليعة. وهذا هو المعنى الأوّل والمباشر لأكتوبر في الكيان الدولي العربي: إنه بدايةُ مرحلةٍ جديدةٍ في «المورفولوجيا السياسية» للدول العربية.
ومن هذا المنطق والمنطلق بالتحديد فرض العربُ على العالم واحدةً — بل سلسلةً — من أكبر وأخطر المتغيّرات في السياسة الدولية بعد أن كانت مصائرُهم رهنًا بالمتغيّرات الدولية تتقاذفها وتعصف بها دون أن تملك — هي — من أمرها شيئًا. لقد كان الجميعُ يتحدّثون طويلًا وكثيرًا عن المتغيّرات الدولية قبل أكتوبر، فأصبح أكتوبر هو أبرزَ المتغيّرات الدولية وأقواها أثرًا. وكان أوضحُ تعبيرٍ عن هذا هو بروزُ شخصيةٍ دوليةٍ عربية على المسرح العالمي.